
لم يكن التكرار معضلة بالنسبة إليه، الروتين هو اللعبة التي يتقنها حد البراعة، والرتابة عنوان يضم حياته بأكملها، تخرج من الثانوية ليدخل الجامعة متخرجا بشهادة في إدارة الأعمال، ليقوم بالانخراط في عمل حكومي إداري معتاد، ومن ثم يتم الضغط عليه حتى يتزوج، صار لديه أربعة من الأبناء، المتوسط المعتاد في مجتمعه، هي ابنة عمه بكل تأكيد، الاستثناء الوحيد في كل ذلك أن لديه القدرة على تأمل هذه الرتابة المتكررة، مستطيع أن يفكر فيها، دون القدرة على فعل شيء تجاه الملحوظات التي يتنبه لها، لأن الإبداع الوحيد في حياته هو هذه القدرة الفريدة على تأمل الذات، أي أنه منذ بداية الوعي لديه، كان متأملًا في متاهته، كما ننظر إليه نحن الآن، و إبداعه يتوقف عند هذا الحد.
زوجته مثله، غير أنها مفتقرة لإبداعه الفريد، القدرة على تأمل الذات منعدمة عندها، الرتابة والاعتيادية نفسها في نفسها وسياق حياتها، ولكن لأن كل إنسان فرادة وإبداع من نوع خاص، فيمكن القول أن الاستثنائية الإبداعية عندها كامنة في قدرتها على الفعل الاعتيادي وليس التأمل في الاعتيادي، زوجها يتأمل في الاعتيادية، وهي تجيد خلق الأحداث العادية بالإضافة للقدرة الفذّة على التعامل مع هذه الأحداث وحسن التسيير لها والتدبير، أي أن الرتابة إن صارت عادية متكررة فوق العادة، فهي لديها القدرة على التنويع فيما هو معتاد وروتيني، هذا هو سر الإبداع عندها.
حتى صداقاته، كانت تنعقد وتنفصم كيفما اتفق، لا قدرة له على الفعل ولا رغبة لديه، متيقظ لمسارات التشكل منتبه لبدايات التفكك، لكنه يتأمل دون مبادرة، وكان ممن يستملحهم الناس في العادة، لا لأنه ممن يبتغي الكل صداقته لأنه يحفز فيهم البواعث والطاقات، بل لأنه ممن يريد جميع الناس عقد علاقة قريبة معه لأنه يذكرهم بالعادي والمعتاد.
ولأن الناس في مجتمعه على الدين، نشأ عليه وأدى واجباته في التربية تجاه الأبناء، وكالمعتاد، لم ينشأ كل واحد منهم كما أراد، لكنهم لم يخذلوا الاعتيادية التي عُجن منها هو وزوجته، فكانوا لهم أبناءً كالمعتاد، ومع مضي الأيام، لم يكن تعامله مع الدين تعامل المتزمت المفاصل، وإنما على طريقة المعتاد اللا معترض، على عكس زوجته، كانت تمارس دور الأم المربية بالأفعال، بكل روتينية، أما هو فقط كان الدين – من حيث الحرارة الإيمانية إن جاز التعبير- فقد كانت في انخفاض.
حتى حل عليه يوم الجمعة الديسمبري، الخامس من الشهر، من عام ١٩٨٠ ، صباح اليوم، يستيقظ من نومه، على بيت خال، مافيه نفس يتردد، يفتش في كل الأنحاء، دون فائدة، حتى وجد دفترا غريبا عند مدخل المنزل فوق الطاولة، فتح الدفتر، وإذا هو دفتر ممتلئ لآخره بالكلام، وفي مقدمته، كتبت الزوجة أنها رسالتها الأخيرة إليه.
قرأ الصفحة الأولى، انتقل للثانية، للتي بعدها، ولأول مرة يشعر بحرارة في الروح تدفع فيه رغبة في التحرك، مصدوم مما وجده، تشرح في الدفتر سبب الاختفاء والهجرة، وأخذ الأولاد معها، وأنهم متفقين معها على خطة تركه، مع شرح لكافة التفاصيل، التي تراكمت معها طوال العشرين سنة التي انقضت بكل هدوء واعتيادية وكأن حرارتها اجتمعت في هذه اللحظات التي قلب فيها الصفحات والنار تكوي روحه.
حاول أن يفهم، تحرك لتدارك الوضع، لكن الدفتر وما احتواه كان فوق القدرة بالنسبة إليه، فكل قدرته منحصرة في تأمل الروتين والمعتاد، وما جرى له يفوق كل روتين معتاد ، كيف ومتى ولماذا، هجمت عليه كلها بشراسة ودون مهلة وتريّث، وتفجرت كل إمكانيات الفعل الخامد عنده نتيجة لانكسار الروتين الغريب هذا. حاول الوصول لهم، لم يستطع، حتى أهلها، لا يعرفون عنها شيئا، مضى على رحيلهم سنة، وكأنها عن خمسين سنة، فقد اضطربت كافة أموره، وانهار كل شيء ، ولم يتوقع يومًا أن يضطر للتفكير في معنى حياته أو ما ينبغي عليه فعله، فالحياة كانت مشرقة وتمضي بروتين هادئ منذ نشأته وحتى اليوم المشؤوم، لكنه منذ رحيل زوجته يواجه قدرا مرعبا يتمثل في ضرورة الإجابة على الأسئلة الملحة: ما معنى هذا الوجود؟ وماهية دوره فيه؟ ولماذا لم يتنبه لهذه الأسئلة إلا بعد وقوع الطامة؟
كان تائها يمضي ذهابًا وعودة في الحدائق المجاورة لمنزله، صبح مساء، طرد من وظيفته نتيجة للغيابات المتكررة، و قد تبقى القليل من مدخراته الوظيفية ومستحقاته، عقله صار يعمل بسرعة مهولة تفكيرا في كل شيء، وروحه مضطربة مشتتة لا تدري كيف الخراج، وصل إلى البحر ، تأمل الشمس قبل الغروب، وتذكر أنه يحب الغروب لكنه غاب عن البحر، طوال فترة زواجه الروتيني الهادئ، ليعود الآن إليه، وفي لحظة من الصفاء والتجلي الضائع، تذكر تعجبّه الشديد أواخر المرحلة الابتدائية، عندما تطرق معلم لمسألة شروق الشمس من الغرب في آخر الزمان، وتذكر جيدا شعوره في ذلك الحين وكافة الأفكار التي حيّرته في هذا الشأن، وأحس فجأة بأنه فهم كل شيء، الدين والناس والعالم والحياة، وأنه بالفعل – كما أحس – ينبغي أن تشرق الشمس من مغربها يومًا ما !

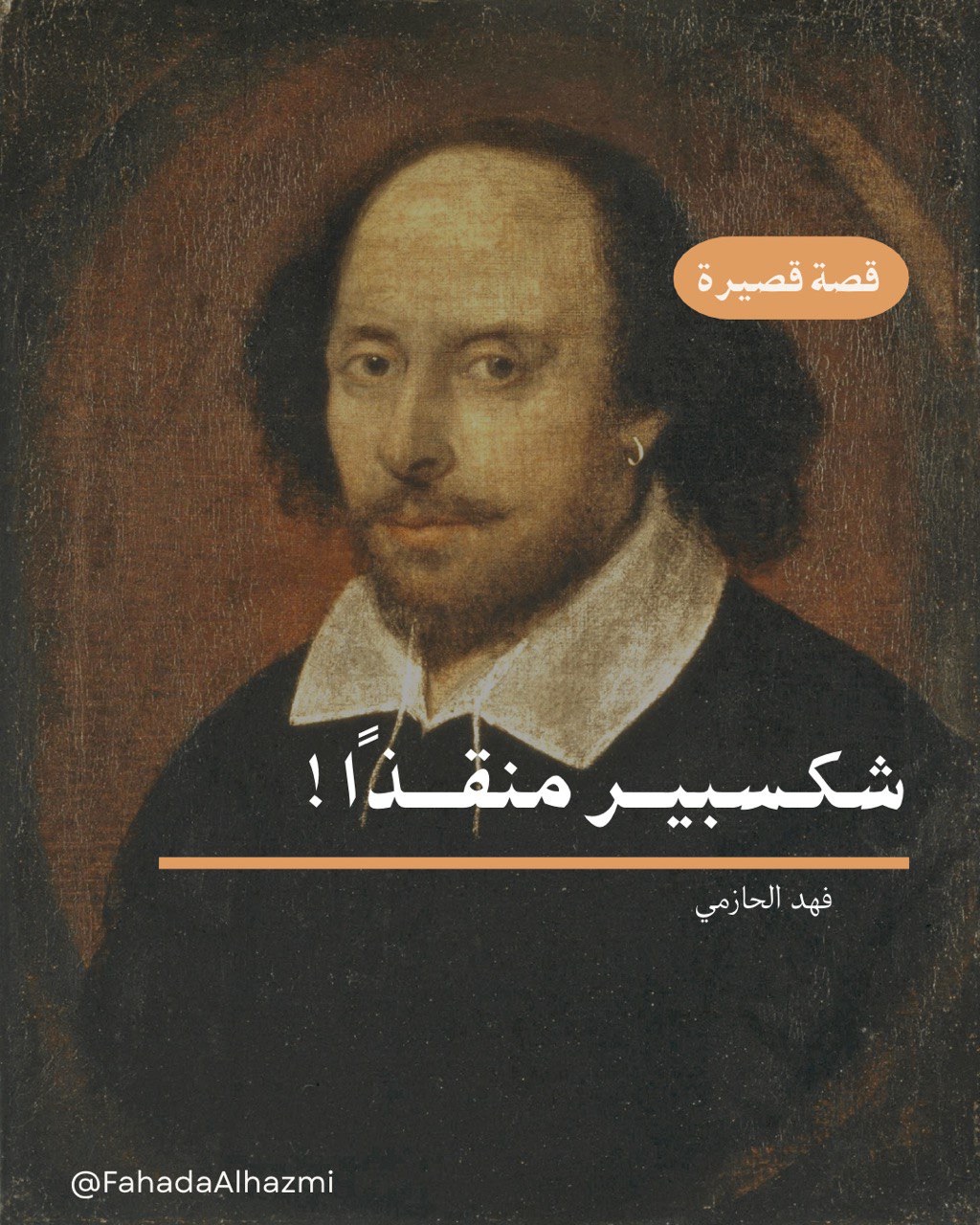


أضف تعليق